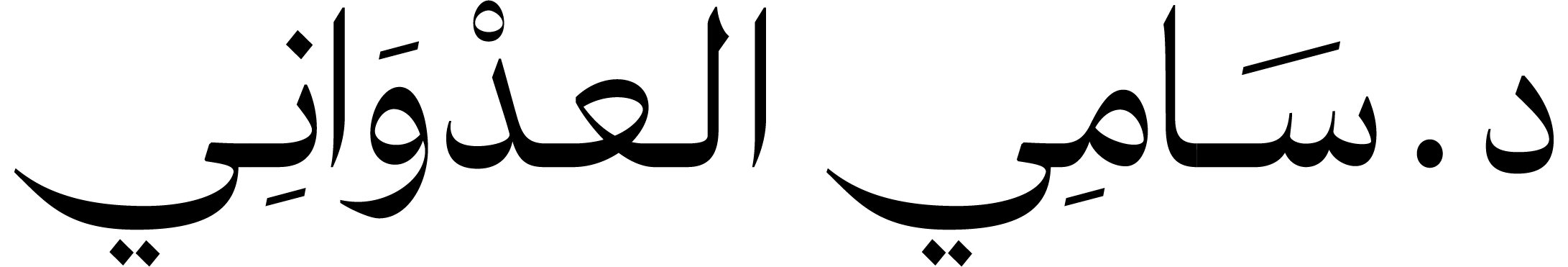تمرّ الأعوام، وتبقى بعض التواريخ محفورةً في الوجدان الجمعي لا تزحزحها السنوات، كلما ابتعدنا عنها زمنًا اقتربنا منها معنى!.
في الثاني من أغسطس من عام 1990، استفاق العرب وعلى الأخصّ منهم ذلك الجيل على وقع جرحٍ غائرٍ في الكرامة، وامتحانٍ عسيرٍ في المواقف والوفاء.
لم يكن الغزو الغاشم مجرد احتلال عسكري، كان صدمة وجودية لهوية مجتمع ودولة، واختبارًا نادرًا لمعدن الناس، وميزانًا حقيقيًا لما تعنيه المواطنة، لا بوصفها إقامة على أرض، إنما الانتماء الذي تترجمه المحن.
في تلك اللحظة المفصلية، كنتُ على عتبة الحياة، بالكاد أفرغتُ يدي من كتب الثانوية العامة، وأنا أتهيأ لخطوتي الأولى في رحلة العمر، لكن القدر شاء أن تكون البداية مختلفة، لم يكن لدينا ترف التأجيل، ولا الوقت الكافي لننضج على مهل .. داهمنا التاريخ قبل أن ندخله، فوجدنا أنفسنا جيلًا يُبتلى في بدايته بأشد ما قد يواجهه إنسانٌ في نهاية عمره.. فقدان الوطن والأمن وغبش المسار نحو المستقبل!.
لكننا صمدنا كجيل .. صمدنا لأن في داخل كلٍّ منّا شعلةً لم تُصنع في المدارس فقط، بل صقلتها البيوت، وربّتها المساجد، وشحذتها التجربة، ولأننا رأينا كيف تحوّل المجتمع ، إلى خلية واحدة من جمعيات تكافل ومقاومة سلطة الاحتلال الغاصب، إلى إعلام الصمود والحشد والتأييد، إلى الأمهات اللاتي أخفين الخوف تحت عباءة الدعاء والثبات، كانت معجزة وطنية لا توصف بالكلمات، لكن أبطالها كانوا عاديين… مثل كل الصامدين أو المغادرين .
لازالت تلك الأقدام التي خطت نحو محراب الصلاة إمامة للناس طوال أيام الغزو، أو تجرأت نحو عتبات المنبر رغم حداثة العلم والعمر، كان \”الزاد اللاهب\” عبارة عن مشاعر لم تُصقل من وعي الخبرة ولا دربة التجربة تجاه الأخطار المحدقة حينها، وكان التطوع دأب تلك المرحلة حين توجهنا لأحد المخابز القريبة واستمر الحال شهوراً في السعي لاستمرار حياة مرافقنا الحيوية، ولازلت أذكر تلك الليالي التي كنّا نقضيها في بيوت الجيران لحماية ممتلكاتهم ودفاعاً عن حق جيرتهم في غيابهم من النهب والسلب الذي شاع وقتها.
واليوم، ونحن نحيي ذكرى تلك المحنة التي تحوّلت إلى منحة أجدني من نتاج ذاك الجيل وأن أوجّه رسائل ثلاث لأبنائنا، أبناء هذا الجيل الرقمي الذي ما عاد يسمع إلا ما يُبثّ له، ولا يثق إلا بمن يُشاركه عبر الشاشة:
أولًا: الوطن ليس جغرافيا، بل مشروع حياة.
أن تحب وطنك لا يعني أن ترفع علمه في المناسبات فحسب، إنما أن تجعل من حياتك امتدادًا لحمايته سواء كان في التزامك، أو أمانتك، أو في وعيك وعطاءك، لقد ناضل آباؤكم ليس فقط دفاعًا عن بيت أو شارع، بل عن فكرة.. أن تكون الكويت حرة، مستقلة، ذات كرامة فحافظوا على هذه الفكرة نية وعزماً.
ثانيًا: الاستدامة ليست مفهوماً بيئيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية.
وأنا أعيش الاستدامة فهماً وثقافة وممارسة أود التأكيد من مجمل التجربة أن الاستدامة تبدأ من الإنسان.. حين انقطعت الكهرباء، تعلّمنا كيف نقتصد ولازلت أذكر ذلك الشيخ الباكستاني الوقور الذي كان يهدي الناس أسرجة النور من مواد أولوية حين تحول المطر إلى رذاذ أسود بفعل حرائق آبار النفط، قدّرنا كل قطرة وحين اختفى الأمن، أدركنا معنى النعمة. فليكن جيلكم رائدًا في وعيه لا في استهلاكه.. في مبادرته لا في انتظاره! ابنوا وطنًا لا يهتزّ حين تهبّ العواصف، لأنكم ثبّتم أساساته على قيمٍ لا تُباع ولا تُشترى.
ثالثًا: الأمان ليس غياب الخطر، بل حضور الوعي!
لن يُبنى مستقبلنا بالخطب أو الأمنيات، إنما بالصبر والبصيرة، والعقول الحاضرة، والقلوب اليقظة..حافظوا على وطنكم كما تحافظون على أرواحكم، ولا تفرّطوا فيه أو تركنوا عن إنتاجه وإنجازه مهما بدا الرفاه والرخاء، فالتاريخ لا يعيد نفسه إلا حين نغفل عنه.
في هذه الذكرى، لا نريد أن نذرف الدموع، بل أن نغرس القيم. لا نريد أن نحكي ما جرى، بل أن نهيئ من يعي إن جرى. فأنتم حماة اليوم، كما حاولنا أن نحمي ونبني في الأمس، وكما سيكون أولادكم ضمان الغد.
فلنجعل من هذه الذكرى إيقاظًا لحاضر، وتأهيلاً لمستقبل لا مجرد تأبينٍ لماضٍ.. وكل ذكرى وأنتم أكثر وعيًا، وأشد صلابة، وأصدق حبًا للكويت.